
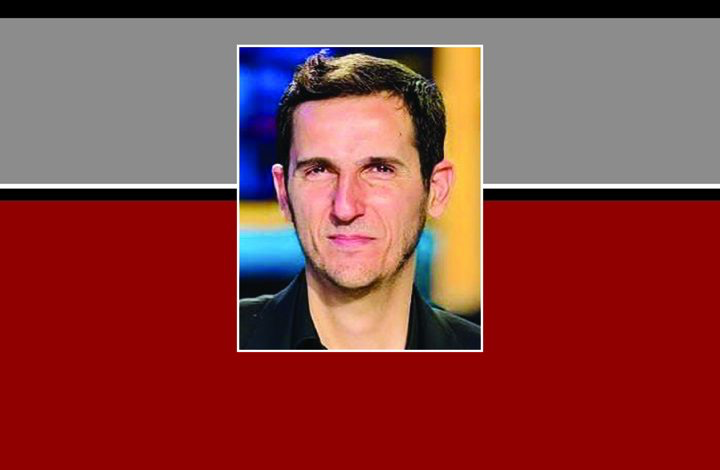
يصعب الإحاطة بمهول التغيّرات التي أصابت عالمنا ومنطقتنا وتأثيراتها العميقة منذ مطلع التسعينات حين ولد دستور الطائف والجمهورية الثانية. عقود تغيّر فيها النظام الدولي مرتين، مرة حين انهيار الاتحاد السوفياتي وأخرى حين فشلت الأحادية الأميركية حيث نعيش تلجلجاتها اليوم.
ومع عظيم التحديات الخارجية وتداعياتها الكيفية فلا يمكن بشكل أن نهمل ونغيّب العامل الداخلي وسياقاته وإرادته، فعدد غير قليل من قوى هذا البلد وأحزابه يعيش مفارقات حادة في نظرته الفعلية للدستور، لا يرونه أكثر من حسبة موازين قوى “مادية” داخلية منها أو خارجية. والحال هذه، فليس المطلوب أكثر من ركوب الرياح والرهان على اختلالات وتقلبات موازين القوة للتغلّب على الشريك. لا تعتبر هذه الظاهرة نادرة فتاريخياً عانى لبنان ممن قارب الوطن بمنظور الحزب أو الجماعة أو الطائفة بل وحتى الشخصنة فأوقع البلد في أزمة تحوّل ثقافة “العمومي” إلى “الخصوصي” مع العلم انّ الدساتير والدول والأوطان لم تُبنَ إلا بتقديم العام كالسيادة (باعتبارها مصداق العام)، لم تُبنَ على موازين القوى أولاً بل على خطاب الثقة والثقافة الجامعة والخير العام والشعور المشترك قبل موازين القوى. لذلك كثيراً ما يُقال أنه قد يستمرّ بلد حتى في ظلّ صراع سياسي حادّ على السلطة لكنه لا يستمرّ بصراع على السيادة وغياب التعريف الموحد للخير العام.
عود على بدء؛ انّ تغيّرات العقود الثلاث الأخيرة خلفت تأثيراتها على لبنان كفكرة وعلى تجربته ككيان ووطن ودولة. وبعيداً من عناء التصنيف لهذه التحوّلات (الخارجي منها والداخلي، الإقليمي منها والدولي)، فإنّ لبنان بما يختلف عن غيره من التجارب انعقدت نطفته على التوالج الكبير بين الداخلي والخارجي فاستغرق الأوائل في تكريس البعد الخارجي كـ إسٍّ في تكوينه وهويته. فكان به أن تأسّس مهجن الهوية مربك السيادة والاستقلال، ولا يزال بنوه يكافحون للكشف عن معنى الوطن والدولة ويتلمّسون الطريق لهذه الحاجة.
في التغيرات الخارجية الرئيسة:
ـ انّ تحوّلا خطيراً ونوعياً حدث في مضمون سياسات الهيمنة نهاية الألفية الثانية، لقد أضافت الولايات المتحدة الأميركية المجال الجيو ثقافي والحضاري الى الجيوبوليتيكي، فتآكلت الحدود الجغرافية وتداخلت بالحدود الثقافية فتخلخل مسار الوحدة وتشظى واقع التنوع فصرنا أمام “دول” مهدّدة في هويتها وقلقة، تعيش قطبيتا السلطة والشعب وتعجز عن مواجهة الإكراهات وآليات الإرغام والإخضاع الخارجي.
أما نحن كلبنانيين فبتنا أمام تحدّ مضاعَف، فالسيادة التي قامت إبتداءاً على الفيزيائي الصلب أيّ الجغرافيا أصبحت تعاني الرخاوة، والدول التي قوامها المرجعية الذاتية الناظمة صارت مرجعيتها مستورَدة او مستدخلة أو مفروضة بالقوة.
ـ باختصار شديد ازداد الإقليم تشوّشاً وتخبّطاً أمنياً واستراتيجياً وثقافياً ولم يعد هناك قضايا تجمع الواقع العربي او مشتركات بل وصلت النوبة أن تعاني كلّ دولة من قصور في تعريف ذاتها بذاتها إلا ما ندر! وغدت البيئة الاقليمية أقرب إلى سيولة شاملة وفوضى منها إلى تركيب او فوضى منظمة! ويزداد الخطر حيث لا يملك أحد داخل الإقليم او خارجه قدرة صياغة تصوّر لنهاية المسار وهيئته. كأننا نسير دون طريق ونقترب من “فك ولا تركيب” و “تشوّش” بلا خيط ناظم.
لسوء الحظ انّ هذا المشهد السوريالي والخطير كان بمثابة فرصة متجدّدة لنخب عربية ولبنانية لتستريح لتنظيرات صناعة الضعف وتكريس التبعية وتبديد مقومات القدرة بدل البحث في استيلاد الفرص وصناعتها وقد ساهم بعضها بقصد لتمييع خطوط الصراع وتضييع الأولويات وتأجيج مزيد من القلق.
بالنسبة للبنان؛ فهو يعيش أخطر محاولة غربية في تاريخه لفرض مرجعية ووصاية أميركية عليه بدل تلكم الثنائية العربية التي رافقت اتفاق الطائف. لقد وصل الحال بالخارج لإشهار طلبه بالصدام الداخلي، ناهيك عن تقريره ودعمه العلني والمطلق لحروب إسرائيلية كانت الأشدّ خلال حرب الـ 66 يوماً واستمرار العدوان الى اليوم مع ما يترافق ذلك من التضييق والحصار الاقتصادي والمالي، وليس انتهاءً بتجاوز لغة الدبلوماسية واستبدالها بلغة الأمر والوصاية وتعويد الشعب على أدبيات “الانتداب”.
ومع ذلك ورغم خطورته، بقيت محاولات الوصاية معلقة. فـ “طوفان الأقصى” و “أولي البأس” شكلا ذلك التمفصل التاريخيّ الأهم. لم يعبّرا عن تغيير سياسي وأمني ضرب المنطقة فحسب بل عن زلزال تاريخي ضرب العالم وتداعياته لن تتوقف في المدى القريب كما يؤكد المراقبون.
لقد عمّق هذا الحدث التاريخي أزمة معنى ومفهوم القوة وموازين القوة، فأكسب جغرافيا المقاومة توسعاً مضطرداً من خلال إعلاء منظور المشروعية والشرعية الدولية والشعبية في العالم رغم الضربات العملياتية التي تلقاها وخسرت نظرية القوة والإفراط فيها من قبل أنظمة الغرب و”إسرائيل” بُعد الشرعية والمشروعية رغم نجاحات أمنية وعسكرية معتدّ بها حققتها. ولن تكون نتائج “السلام بالقوة” أفضل من مسار “السلام الأميركي” في تسعينيات القرن الماضي حين كان الوزن الأميركي حاسماً ووزن جبهات مواجهة الهيمنة ضئيلاً جداً مقارنة باليوم.
انّ الصمود هنا والثبات شكلا سبب التأرجح في تحديد صورة المنطقة وهيئتها بعدما عجزت أخطر جولة منذ نشوء الكيان الصهيوني من الحسم ونحن اليوم في خضمها.
أما سورية التي شكلت أحد أضلع الواقع العربي ومعادلاته التاريخية فتعاني اليوم من احتلال “إسرائيلي” مباشر ومن سعي أميركي تركي لإعادة إنتاج دورها الجديد ولم تعد ذلك الموازن والمكافئ العربي وثالث أضلع المثلثات العربية التي شكلت سمة العقود الماضية إلى جانب مصر والسعودية. فالدولة الأكثر تداخلاً مع لبنان مساراً ومصيراً وتاريخاً يفرض عليها التطبيع بالقوة والنار وتستخدم حكومة انتقالية لتهريبه، وتختلف إردات القوى الخارجية عليها وعلى دورها المستقبلي والحدود المرجوة بين “تماسكها وتشظيها”. ولبنان اليوم ينتظر بقلق السياق السوري ونتائجه على لبنان.
أما بقية الدول العربية، فلا شك أنها أمام واقع هو الأصعب في تاريخها فالتحديات تدهمها بالفعل او بالقوة، ولا تكاد دولة عربية تتفق مع أخرى في مقاربة لازمة من الأزمات او في الصراع (مؤخراً تفاقم التباين المصري السعودي والقطري السعودي والمصري الإماراتي على مجمل القضايا الساخنة والملتهبة في المنطقة ومنها فلسطين ولبنان وإلخ…). ويندّر أن تجد دولة عربية قادرة ان تعرّف وتدافع عن محدّداتها الأمنية ومصالحها الحيوية، وأغلبهم لا تزال تصوّراتهم للأمن والمصالح والنفوذ والتأثير تخضع بنسب متفاوتة لتأثير خارجيّ، وهذا ما يخلف قلقاً مضاعفاً إزاء المستقبل خصوصاً عندنا كلبنانيين فكلّ منهم يريد من لبنان وللبنان شيئاً ويرسم له أجندة…
وليس آخر المتغيّرات وربما أخطرها على المستقبل هو ما نشهده من سعي إسرائيلي أميركي محموم لتوسعة جغرافيا “اسرائيل” فأميركا التي ارتبط خطابها بحماية الكيان ذات يوم تقدّم نفسها الآن كراع لتمدّد الكيان مع كلّ ما سيخلفه ذلك من تداعيات مصيرية على آحاد الدول وعلى الإقليم بالسواء.
كلّ هذه التغيّرات السياسية والاستراتيجية وغيرها من تحوّلات اقتصادية وثقافية عميقة لا يتسع المبحث لتفصيلها والتعرّض لآثارها الكبيرة تطرح علينا سؤالاً جوهرياً لجهة تعاطينا معها وتشخيص حدود تأثيرها على عقدنا الاجتماعي وركائزه، وماذا ستكون النتيجة لو سلّمنا لها باعتبارها قدراً او سياق تغلب داخلي، فالاستهتار وعدم الاستشراف وغياب تحديد بيّن للمصالح اللبنانية الحيوية سيضيف تراكم الكمّي الذي قد يتحوّل إلى كيفي يطفو في لحظة لا يمكن التنبّؤ بها كما تفيد دراسات المجتمعات ومنطق التاريخ، فهل لنا ان نقرأ في أحشاء الزمن بدل الاستغراق في التسطيح واللامسؤولية، وهل لنا ان نتذكر المقولات الأولى أنه عند الشدائد وحين تتهدّد البنى يفضل اللجوء إلى ما هو متوافر من الثوابت بدل المناورة عليها والتلاعب بها.